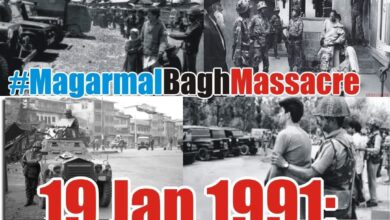الصدى الذي لا ينتهي: 27 أكتوبر و”اليوم الأسود” الدائم في كشمير

إيلسا أزهر
بالنسبة لمعظم العالم، التاريخ فصلٌ يُقرأ، وتاريخٌ يُحفظ. بالنسبة لشعب جامو وكشمير، 27 أكتوبر 1947 ليس سطرًا في كتاب مدرسي؛ بل ندبةٌ غائرةٌ في أعماق الروح الجماعية.
جرحٌ ظلّ مفتوحًا لستةٍ وسبعين عامًا، يومٌ محفورٌ في الذاكرة كـ”يومٍ أسود” – لحظةُ سلب حقهم غير القابل للتصرف في تقرير مستقبلهم، وبدء احتلالٍ دام لأكثر من ثلاثة أجيال.
تكمن جذور هذا الصراع المستمر في العواقب المضطربة لتقسيم شبه القارة الهندية. فمع تفكك الحكم البريطاني، مُنحت الولايات الأميرية الـ 565 خيارًا: الانضمام إلى الدولتين المتشكلتين حديثًا، الهند أو باكستان، أو المخاطرة بمسار الاستقلال المحفوف بالمخاطر.
وبدت كشمير، بأغلبيتها السكانية الساحقة من المسلمين، وشرايينها الجغرافية والثقافية والاقتصادية التي تمتد غربًا إلى لاهور وروالبندي، جزءًا لا يتجزأ من باكستان.
إلا أن حاكمها الهندوسي، مهراجا هاري سينغ، تردد، إذ كان حكمه الاستبدادي يترنح تحت وطأة ثورة شعبية. انفجر هذا السخط في انتفاضة بونش أواخر عام ١٩٤٧، حيث بدأت الميليشيات الكشميرية بتحدي سلطة المهراجا بنجاح
بالنسبة لمعظم العالم، التاريخ فصلٌ يُقرأ، وتاريخٌ يُحفظ. بالنسبة لشعب جامو وكشمير، 27 أكتوبر/تشرين الأول 1947 ليس سطرًا في كتاب مدرسي؛ بل ندبةٌ غائرةٌ في أعماق الروح الجماعية. جرحٌ ظلّ مفتوحًا لستةٍ وسبعين عامًا، يومٌ محفورٌ في الذاكرة كـ”يومٍ أسود” – لحظةُ سلب حقهم غير القابل للتصرف في تقرير مستقبلهم، وبدء احتلالٍ دام لأكثر من ثلاثة أجيال.
تكمن جذور هذا الصراع المستمر في العواقب المضطربة لتقسيم شبه القارة الهندية. فمع تفكك الحكم البريطاني، مُنحت الولايات الأميرية الـ 565 خيارًا: الانضمام إلى الدولتين المتشكلتين حديثًا، الهند أو باكستان، أو المخاطرة بمسار الاستقلال المحفوف بالمخاطر. وبدت كشمير، بأغلبيتها السكانية الساحقة من المسلمين، وشرايينها الجغرافية والثقافية والاقتصادية التي تمتد غربًا إلى لاهور وروالبندي، جزءًا لا يتجزأ من باكستان.
إلا أن حاكمها الهندوسي، مهراجا هاري سينغ، تردد، إذ كان حكمه الاستبدادي يترنح تحت وطأة ثورة شعبية. انفجر هذا السخط في انتفاضة بونش أواخر عام ١٩٤٧، حيث بدأت الميليشيات الكشميرية بتحدي سلطة المهراجا بنجاح.
ولا يزال المؤرخون يتجادلون حول ما إذا كانت قد صدرت بالإكراه، أو بتواريخ سابقة، أو مُزوّرة بشكل مباشر. لكن ما لا خلاف عليه، وما يُؤجج المظالم الكشميرية، هو حقيقة واحدة صارخة: لم يُستشار أي مواطن كشميري.
في صباح اليوم التالي، تجلّى ذلك التوقيع عمليًا بإنزال القوات الهندية في مطار سريناغار. ما وصفته حكومة نيودلهي بأنه “إجراء دفاعي مؤقت” لصد الميليشيات القبلية.
أصبح، في التجربة الكشميرية، اليوم الأول للاحتلال العسكري الدائم. سارع الجنود الهنود إلى تأمين المطار، ثم المدينة، ثم بدأوا زحفهم نحو الوادي.
سارع المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالنزاع. وأُحيل الأمر على عجل إلى الأمم المتحدة، التي أصدرت قرارات في عامي ١٩٤٨ و١٩٤٩ تؤكد وضع كشمير كإقليم متنازع عليه.
وعدت هذه القرارات بحلٍّ ديمقراطي بسيط: استفتاء حرّ ونزيه يسمح للشعب الكشميري بتقرير مصيره. لكن هذا الوعد، الذي قُطع للعالم رسميًا، لا يزال حبرًا على ورق، شبحًا يطارد سياسات المنطقة.
على مر العقود، تحوّل “الانتشار المؤقت” إلى أضخم شبكة عسكرية في العالم. تشير التقديرات اليوم إلى وجود جندي واحد تقريبًا لكل ثمانية مدنيين كشميريين.
هذا الاحتلال ليس مفهومًا مجردًا، بل هو واقع يومي مؤلم. تخترق نقاط التفتيش والمخابئ بساتين التفاح وساحات المدارس والمقابر القديمة. ويُفرض حظر التجول عبر رسائل نصية مفاجئة.
أعمت بنادق الخرطوش المرعبة، التي تبدو غير قاتلة ظاهريًا، مئات المراهقين. وتخفي الجبال أسرارًا مظلمة في شكل مقابر جماعية مجهولة.
وتُجيز تشريعات مثل قانون السلامة العامة (PSA) وقانون الصلاحيات الخاصة للقوات المسلحة (AFSPA) الاحتجاز دون محاكمة واستخدام القوة المميتة مع الإفلات من العقاب، مما يخلق بيئة تغيب فيها المحاسبة.
هذه الصدمة ليست حدثًا فرديًا، بل إرث تراكمي. الأجداد الذين شاهدوا طائرات داكوتا الهندية تُظلم السماء عام ١٩٤٧، يشاهدون الآن أحفادهم يواجهون نفس نماذج البنادق.
العائلات مُشتتة، مُنقسمة بين من بقوا في ظل الصراع ومن فروا عبر خط السيطرة إلى آزاد كشمير أو إلى منفى مُحفوف بالمخاطر في الخارج.
نشأ جيل من الأطفال وهم ينطقون كلمة “آزادي” (الحرية) قبل أن يتعلموا تهجئتها. والأثر النفسي كارثي؛ فقد وجدت دراسة أجرتها منظمة أطباء بلا حدود عام ٢٠٢٢ أن ما يقرب من نصف البالغين في كشمير يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، وهو دليل على مجتمع يعيش في حالة حصار دائم.
ومع ذلك، فإن “اليوم الأسود” ليس مجرد يوم حداد. إنه تقويم للمقاومة، وتأكيدٌ مُتحدٍّ للهوية، ووعدٌ مُنكرٌ بتقرير المصير. في السابع والعشرين من أكتوبر من كل عام، ورغم الوجود الأمني المُكثّف، وانقطاع الإنترنت، والاعتقالات الاستباقية، يجد الكشميريون سبلًا للتعبير عن أنفسهم.
يُنظّمون مسيراتٍ مُتحدّين المتاريس، ويرفعون الأعلام الباكستانية من أسطح المنازل، ويخطّون شعاراتٍ على أبواب متاجرهم المُغلقة: “نريد استفتاءً، لا خرطوشًا”.
يعجّ العالم الرقمي، عند توافره، بمقاطع فيديو لنساء يُحدثن ضجيجًا من الاحتجاجات بقرع الأواني والمقالي، ولطلاب يسيرون في حرم الجامعات المُغطّى بالضباب.
هذه الأفعال ليست مجرد احتجاجات؛ بل هي فعلٌ واعيٌّ للحفاظ على ذكرى قرارات الأمم المتحدة، مُتحدّيةً بتحدٍّ الرواية الرسمية الهندية القائلة بأن كشمير “جزءٌ لا يتجزأ” من الإقليم، والتي سُوّيت من خلال الانتخابات المحلية وحزم التنمية الاقتصادية.
في كشمير، تُستخدَم الذاكرة نفسها ضد النسيان. تروي الجدات دويّ طائرات داكوتا. يتذكر الآباء أول طقطقة مرعبة لبندقية عيار 303.
ينشر المراهقون، أبناء المقاومة الرقميون، صورًا مؤرشفة من عام 1947 على مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليقات تقول: “ما زلنا ننتظر”.
“اليوم الأسود” أرشيف حي، رفض جماعي لترك الماضي يتحجر في حنين حميد. إنه تذكير قوي بأن الاحتلال ليس مجرد وجود قوات أجنبية، بل هو غياب منهجي ومؤلم للخيارات.
لم ينتهِ الإنزال عام ١٩٤٧، بل لا يزال مستمرًا. يتردد صداه في هدير قوافل الجيش وهي تشق طريقها على طريق سريناغار-جامو السريع، وفي طرق أخرى لا تُحصى عبر وديان كشمير، وتشيناب.
وبير بانشال. ويزداد صداه مع كل غروب شمس عندما تُعلن مكبرات الصوت عن قيود جديدة، ويمتلئ الليل بقلق الغارات التي تُقرع الأبواب.
لكن المقاومة مستمرة أيضًا. إنها تتجلى في قصائد تُهمس بها أصواتٌ خافتة، وفي رسومات غرافيتي تظهر فجأةً على الجدران، وفي غرس الأعلام على الجسور المهجورة.
وهو أمرٌ مُستعصي وخطير. إلى أن يتحقق وعد الاستفتاء أخيرًا، سيظل يوم 27 أكتوبر جملةً ناقصةً في تاريخ كشمير حذفٌ سنويٌّ يُطالب العالم بإكمال الفصل الذي بدأه عام 1947: أن يتركوا الشعب الكشميري يختار مصيره بسلامٍ وكرامة.