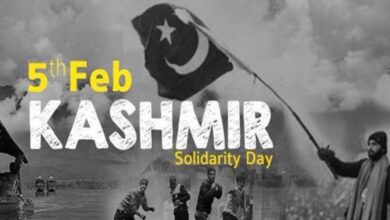ما وراء الرصاص والحدود: الصمت الاستراتيجي والوحشية المنهجية في جامو وكشمير المحتلة

بقلم: إحسان علي
لا يزال نزاع كشمير يمثل إحدى أعقد بؤر التوتر في الجغرافيا السياسية لجنوب آسيا، إذ يقوم على مطالبات إقليمية غير محسومة، وقوميات متنافسة، ومعاناة إنسانية مزمنة. وعلى الرغم من أن الصراع كان يُفهم تقليديًا من خلال الحروب والمواجهات العسكرية والأزمات الدبلوماسية، فإنه دخل في السنوات الأخيرة مرحلة أكثر خفاءً وتعقيدًا.
تتسم هذه المرحلة بما يمكن وصفه بـ«الصمت الاستراتيجي» بين الهند وباكستان، يقابله تصاعد ملحوظ في عنف الدولة الهندية داخل جامو وكشمير المحتلة بصورة غير قانونية. وتكشف السياسات المتبعة منذ عام 2019، إلى جانب حوادث لاحقة مثل واقعة باهالغام عام 2025، عن انتقال واضح من نمط الحكم الإداري إلى القمع الممنهج، في ظل تهدئة دبلوماسية واحتواء مدروس للرواية الإعلامية.
في 22 أبريل/نيسان 2025، أسفر حادث دموي في منطقة باهالغام عن مقتل عدد من المدنيين، ما أثار موجة غضب واسعة في جنوب آسيا. غير أن رد فعل الحكومة الهندية لم يتجه نحو تحقيق شفاف أو مساءلة قانونية، بل كشف عن بنية قمعية أعمق تتجاوز منطق الحماية الأمنية.
عقب الحادث، صعّدت نيودلهي من انتشارها العسكري وشبه العسكري، وفرضت إجراءات عقابية واسعة، ونفذت حملات اعتقال جماعية في مناطق مختلفة من جامو وكشمير المحتلة. ولم تُقدَّم هذه التدابير كاستجابة محدودة، بل كجزء من سياسة ردع شاملة طالت المجتمع بأكمله.
تمثل هذه الممارسات انتهاكًا واضحًا لمبادئ الإجراءات القانونية الواجبة ومبدأ التناسب المنصوص عليهما في القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقيات جنيف والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية لعام 1990. وقد وثقت منظمات حقوقية استخدام القوة المفرطة ضد متظاهرين عُزّل، وفرض عقوبات جماعية على أسر الضحايا، وقطع الاتصالات لفترات مطولة.
بدلًا من معالجة الأسباب الجذرية للتوتر، استخدمت السلطات الهندية حادثة باهالغام ذريعة لتوسيع نطاق السيطرة القسرية، وتعميق القيود السياسية، وترسيخ منظومة المراقبة الشاملة. وفي المقابل، ظل التفاعل الدولي محدودًا، إذ لجأت باكستان إلى المسارات القانونية، بينما أصرت الهند على توصيف الأزمة كمسألة داخلية، في تجسيد واضح للصمت الاستراتيجي السائد منذ عام 2019.
منذ إعادة هيكلة وضع جامو وكشمير عام 2019، تحولت عمليات قطع الاتصالات وإغلاق الإنترنت إلى أدوات اعتيادية للسيطرة السياسية، لا إلى إجراءات أمنية استثنائية. فكل احتجاج أو تحرك سياسي أو حادث أمني تقريبًا يُقابل بقيود ممنهجة على تدفق المعلومات، تمتد أحيانًا لأسابيع أو أشهر.
لا يقتصر هذا الإغلاق على تعطيل وسائل التواصل الاجتماعي، بل يشمل حرمان السكان من الوصول إلى الأخبار، والآليات القانونية، والتعليم، والرعاية الصحية، وخدمات الطوارئ. ويضع ذلك المجتمع المحلي في حالة عزلة قسرية شاملة، تنتهك بشكل مباشر المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ورغم التحذيرات المتكررة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، أصبح القمع الرقمي ممارسة طبيعية، تُستخدم لإخفاء الانتهاكات ومنع التوثيق المستقل بصورة منهجية.
إلى جانب ذلك، برز الاعتقال التعسفي كأداة مركزية في القمع السياسي. فقد طالت الاعتقالات آلاف السياسيين، ونشطاء المجتمع المدني، والمحامين، والطلاب، والصحفيين، استنادًا إلى قوانين مكافحة الإرهاب ذات الصياغات الفضفاضة، وعلى رأسها قانون السلامة العامة.
يتيح هذا القانون الاحتجاز لفترات طويلة دون توجيه تهم أو محاكمة، في انتهاك صريح للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وبدلًا من حماية الأفراد من تعسف السلطة، أُعيد توظيف النظام القانوني كوسيلة إدارية لتجريم المعارضة وتفكيك العمل السياسي المنظم.
يعكس الاستخدام المنهجي للقوة المفرطة الطبيعة القسرية للحكم في الإقليم. فقد أدى الاعتماد المستمر على بنادق الخرطوش في تفريق الحشود إلى إصابات واسعة، وفقدان دائم للبصر، ووفيات بين المدنيين. ورغم الإدانة الدولية المتكررة لهذه الأسلحة بسبب عشوائيتها وآثارها الدائمة، لا تزال تُستخدم بشكل روتيني.
يمثل ذلك انتهاكًا واضحًا لمبادئ الأمم المتحدة التي تشترط أن يكون استخدام القوة ضروريًا ومتناسبًا ومحدودًا. ولا يعكس هذا السلوك تجاوزات فردية، بل منطقًا عقابيًا متجذرًا في العقيدة الأمنية السائدة.
إلى جانب القمع الأمني، أضافت الهندسة الديموغرافية بُعدًا هيكليًا طويل الأمد للانتهاكات. فقد سمحت القوانين الجديدة الخاصة بالإقامة والملكية، التي أُقرت بعد عام 2019، بتوطين غير السكان المحليين وتغيير شروط الإقامة، ما أعاد تشكيل الواقع الديموغرافي والسياسي للإقليم.
ورغم تقديم هذه السياسات على أنها إصلاحات إدارية تهدف إلى التنمية، فإن آثارها السياسية عميقة، إذ تهدد التركيبة السكانية ذات الأغلبية المسلمة، وتُضعف التمثيل السياسي للسكان الأصليين، وتقوض الهوية الجماعية للكشميريين. وتحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة صراحة مثل هذه الممارسات في الأراضي المحتلة.
مجتمعة، تشكل هذه السياسات نمطًا متكاملًا من الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. فالعقاب الجماعي، والاحتجاز التعسفي، وقمع حرية التعبير، والاستخدام المفرط للقوة، والتلاعب الديموغرافي، جميعها محظورة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ورغم إصرار الهند على اعتبار هذه الإجراءات شؤونًا داخلية، فإن الوضع القانوني غير المحسوم لجامو وكشمير وفق قرارات مجلس الأمن الدولي يجعل هذه الادعاءات محل طعن قانوني مستمر.
وعلى الرغم من المناشدات المتكررة من منظمات حقوق الإنسان والمقررين الخاصين للأمم المتحدة، لا تزال المساءلة غائبة. فقد أدى الموقف الدبلوماسي الهندي، إلى جانب الحسابات الجيوسياسية الدولية، إلى شلل في الاستجابة العالمية.
تصدر الإدانات، وتُرفع التقارير، وتُسجل المخاوف، لكن آليات الإنفاذ تظل معطلة. وفي هذه المفارقة بين الوحشية المحلية والصمت الدولي تتجسد المرحلة الراهنة من نزاع كشمير، حيث يُخفي الهدوء الاستراتيجي خطورة الواقع، بينما يواصل المدنيون الكشميريون دفع الثمن الإنساني المتراكم، في ظل عالم منشغل ومتردد.