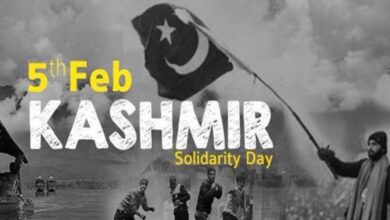ضريبة كشمير على الإرهاب: دفع ثمن إخفاقات الهند الأمنية بأرواح الأبرياء

بقلم: شازيا أشرف خوجه
أعاد انفجار السيارة قرب القلعة الحمراء في دلهي في العاشر من نوفمبر إحياء أكثر ردود الفعل الأمنية الهندية توقعًا وعارًا: الاضطهاد الجماعي للكشميريين.
في غضون أربعة أيام، اعتُقل أكثر من 1500 كشميري، وداهمت آلاف المنازل، ووُضع مجتمع بأكمله تحت طائلة الشك الجماعي. هذه ليست مكافحة للإرهاب؛ بل هي عقاب جماعي ترعاه الدولة، وهو طقسٌ بشع يدفع فيه الكشميريون ثمن إخفاقات المؤسسة الأمنية الهندية.
هذا النمط قديمٌ بقدم الصراع نفسه. فكل انفجار على الأراضي الهندية يُصبح ذريعةً لتجريم شعب بأكمله، بينما يظل الجناة الحقيقيون غالبًا بعيدين عن الأنظار، ويظل العجز المؤسسي الذي سمح بهذا الهجوم دون أي دراسة.
إن دليل هذا الظلم المنهجي ليس قصصيًا؛ بل هو موثق، ومؤكد قضائيًا، ومُدان. منذ تسعينيات القرن الماضي، أتقنت أجهزة الأمن الهندية فنّ اختلاق الذنب، وتأمين الإدانات من خلال أدلة ملفقة واعترافات قسرية، فقط لكي تُلغي المحاكم العليا هذه الأحكام بعد أن فقد رجال أبرياء عقودًا من حياتهم.
تُجسّد قضية انفجار قنبلة لاجبات ناجار عام ١٩٩٦ آلية الظلم هذه: فقد أمضى محمد رفيق شاه، وهو طالب يبلغ من العمر ١٩ عامًا، ١٤ عامًا في السجن قبل أن تبرئه محكمة دلهي العليا، واصفةً التحقيق بأنه “رديء” والأدلة بأنها “مُلفّقة”.
كما عانى زملاؤه الطلاب – محمد حسين فاضلي، ومحمد علي بهات، وإشفاق أحمد – من جحيم مماثل، حيث سُجنوا لمدة تتراوح بين ١٢ و١٤ عامًا قبل أن يُعلن براءتهم. لم تكن هذه أخطاءً معزولة، بل كانت نموذجًا.
شهد هجوم البرلمان عام 2001 إعدام أفزال جورو رغم عدم وجود أدلة قاطعة، بينما حُكم على سار جيلاني، الأستاذ بجامعة جاميا ميليا دلهي، بالإعدام قبل أن تبرئه المحكمة العليا بعد عامين، مما سلّط الضوء على كيفية إساءة تفسير المؤهلات الأكاديمية على أنها أصول إرهابية.
في عام 2005، بُرّئ رجل الأعمال الكشميري طارق أحمد دار من تهم الإرهاب في تفجيرات ديوالي في دلهي، لكنه ظل مسجونًا بموجب قانون منع الإرهاب بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية”.
خارج دلهي، أمضى ميرزا افتخار حسين خمس سنوات في سجون أوتار براديش قبل تبرئته، وقضّى غلام محمد بهات أربع سنوات في غوجارات، وقضى تاجران 18 شهرًا في تفجيرات جايبور عام 2008 قبل أن تجد المحاكم “عدم وجود أدلة”.
هذه ليست مجرد إحصاءات؛ إنها حياة مُدمرة بشكل ممنهج. تتراوح فترات السجن قبل التبرئة بين 3 و14 عامًا. تستشهد المحاكم بـ”أدلة مُلفقة” و”تحقيقات فاسدة” و”اعترافات قسرية”، ومع ذلك لا يُحاكم أي ضابط.
التعويضات، التي تتراوح بين 6000 و12000 دولار، تُسخر من عقودٍ سُرقت، ومسارات مهنية مُدمرة، وعائلات مُشتتة. لا تزال العديد من الحالات غير مُوثقة لأن العائلات تخشى الاضطهاد أو تفتقر إلى الموارد.
هذا ليس عدالة مُؤجلة، بل يُحرم منها عمدًا، ويُجعل الكشميريون كبش فداء لإظهار “النتائج”.
تتبع الحملة الحالية هذا السيناريو الإجرامي بدقة متناهية. إن توجيه شرطة جوروغرام بتجميع قوائم بسكان كشمير ليس إجراءً أمنيًا، بل هو إضفاء طابع رسمي على نظام الفصل العنصري، يُختزل المواطنة في جغرافية محددة، ويُحوّل كل كشميري إلى مشتبه به دائم.
يعكس هذا نموذجًا أمنيًا مدفوعًا بالهندوتفا، يُعامل المسلمين الكشميريين كعدو لا كمواطنين. إن دعوة نائب الحاكم مانوج سينها لتحديد “العناصر غير الاجتماعية” تبدو واهية، في حين يُفترض أن المجتمع بأكمله غير اجتماعي بطبيعته.
تُطالب الدولة بالتعاون، بينما تُمارس العقاب الجماعي، مما يُنشئ حلقة مفرغة، حيث يكون الاغتراب سببًا ونتيجةً للسياسة في آنٍ واحد.
ما يجعل هذه الدورة شريرةً بشكل خاص هو فائدتها السياسية. وصف كبار الصحفيين تفجيرات دلهي السابقة بأنها “تفجيرات سياسية” – أحداثٌ استُخدمت لحشد التأييد لحملات القمع وتحقيق مكاسب انتخابية.
تتصاعد التحذيرات الأمنية عندما تضطر الحكومات إلى الظهور بمظهر الحازم، وتظهر “وحدات الإرهاب” عندما تطالب العناوين الرئيسية بالهيمنة. هذه ليست نظرية مؤامرة؛ إنها إدراكٌ للأنماط.
الخطاب المتهور حول “دخول المنازل للقتل” يصرف الانتباه عن إخفاقات الحكم، ويُطبّق حالة طوارئ دائمة حيث يُمكن تجريم مجتمعات بأكملها دون احتجاج شعبي.
يُجسّد قانون مكافحة الإرهاب، الذي يُحتجز بموجبه معظم الكشميريين، الاستبداد القانوني. فمع نسبة إدانات تقل عن 2%، وفترة حبس مطولة قبل المحاكمة، يُعتبر هذا القانون بمثابة عقاب بلا إجراءات قانونية.
تُدرك الأجهزة الأمنية ضعف الأدلة، لكنها تستخدم الاحتجاز لإبعاد الكشميريين، وإسكات المعارضة، وفرض سلطة الدولة. هذه استراتيجية، وليست عجزًا، تجعل حياة كل كشميري مُهمَلة.
لقد ارتقت الحكومة التي يقودها الهندوتفا بهذا الاضطهاد إلى مستوى السياسة. فمن خلال استهدافها الممنهج للمهنيين الكشميريين من أطباء ومحامين وأكاديميين تهدف إلى سحق قيادة المجتمع وخلق هجرة للعقول تجعل الوادي فارغًا فكريًا وسهل السيطرة عليه.
وتُعدّ المحاولات المبهمة “لتشويه صورة الأطباء الكشميريين” جزءًا من هذا المخطط: فعندما يُصوَّر المعالجون على أنهم تهديد، ينهار النسيج الاجتماعي بأكمله.
هذه حرب نفسية، مُصمَّمة لجعل الكشميريين يشككون في بعضهم البعض، والدولة تشكك في كل كشميري. إن تحذير السفر الصادر عن المملكة المتحدة، على الرغم من ضرره الاقتصادي، ليس سوى مصادقة خارجية على ما يعرفه الكشميريون منذ زمن طويل: إنهم يعيشون في منطقة يُرادف فيها الأمن العقاب الجماعي.
يستحق ضحايا القلعة الحمراء العدالة، لكن لا يمكن أن تأتي على حساب الكشميريين الأبرياء. فالاعتقالات الكاذبة تُولّد مظالم، والقضايا الملفقة تُبرّر روايات الانفصاليين، والكشميريون المُبرّؤون يشهدون على ظلمٍ مُمنهج، بينما يزدهر نظام الإرهاب الحقيقي في أروقة الشرطة والسياسة.
المطلوب ليس توسيع شبكة الملاحقة الأمنية، بل تفكيكها بالكامل. يجب التحقيق مع الجهات التي تُلفّق الأدلة، ومحاكمة الضباط المسؤولين عن تلفيق التهم في هجوم لاجبات ناجار والبرلمان.
يجب إلغاء قانون مكافحة الإرهاب، وسحب توجيه التنميط في جوروغرام مع تقديم اعتذار علني. يجب أن يكون تعويض المسجونين ظلماً كبيراً وتلقائياً، لا صراعاً يستمر عقوداً.
والأهم من ذلك، يجب على القيادة السياسية التخلي عن الوهم الخطير القائل بأن الأمن لا يمكن أن يُبنى إلا على إذلال شعب بأكمله.
كان انفجار دلهي فشلاً ذريعاً في الاستخبارات والوقاية والأنظمة المصممة لحماية المواطنين. يجب أن يتحمل المسؤولون عن هذا الفشل مسؤوليته، لا أن يُعهد به إلى جهات خارجية كعقاب جماعي للكشميريين.
إلى أن تواجه الهند الفساد المؤسسي في أجهزتها الأمنية والسم الطائفي في القيادة السياسية، فإن كل انفجار سينفجر مرتين: مرة في دلهي، ومرة أخرى في منازل الكشميريين الأبرياء الذين أدركوا أن حريتهم، في أكبر ديمقراطية في العالم، هي دائماً الضحية الأولى للإرهاب.