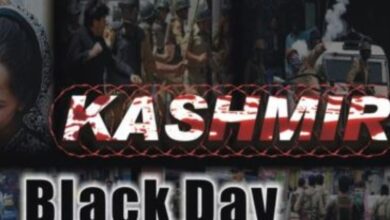السيد التيجاني يكتب: كشمير وفلسطين.. صراع القمع والحرية

عندما أنظر إلى ما يحدث في كشمير وفلسطين، أشعر بمرارة غريبة. كأنني أشاهد حلقتين متطابقتين من مسلسل مأساوي، تختلفان فقط في الأسماء والخرائط.
على مدار السنوات الماضية، لاحظت كيف أن الهند، تحت ذرائع الأمن الوطني، تتبع نهجًا يشبه تمامًا ما نراه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
التوسع الاستيطاني، التغيير الديموغرافي، السيطرة العسكرية، وطمس الهوية الوطنية للسكان الأصليين، كلها أدوات واحدة، مستخدمة في سياقات مختلفة، ولكنها تؤدي إلى نتيجة واحدة: الشعور بالغبن والقهر لدى السكان الأصليين.
في جامو وكشمير، بعد إلغاء الوضع الخاص للإقليم عام 2019، بدأت الهند مباشرة في تغيير معالم الواقع هناك. أراضٍ تُمنح لمستثمرين من خارج الإقليم، مراقبة صارمة، ووجود أمني مكثف. كل هذه الخطوات تُعلن الحكومة الهندية أنها ضرورية لتعزيز “الاستقرار” و“الاندماج الوطني”.
ولكن إذا تأملت الواقع على الأرض، سترى أن السكان المحليين يشعرون بالتهجير والقمع اليومي. هذا الشعور لا يختلف كثيرًا عن ما يعيشه الفلسطينيون في الضفة الغربية وغزة.
كنت دائمًا من أشد المراقبين لتقارير الإعلام المستقل والمنظمات الحقوقية، وما يثير قلقي بشكل خاص هو التعاون بين الهند وإسرائيل في مجال الأمن والمراقبة.
الهند، التي غالبًا ما تصف نفسها بالديمقراطية النامية، تتعلم من خبرة إسرائيل في السيطرة على الأراضي المحتلة.
وهو ما يفسر جزئيًا التطورات في كشمير. بالنسبة لي، هذا التعاون ليس مجرد صفقات سلاح، بل نقل خبرات قمعية وأساليب السيطرة الاجتماعية والسياسية، وهو أمر يثير التساؤل حول الضوابط الأخلاقية في السياسة الدولية.
ما لاحظته بعمق، هو أن كلا النموذجين – الهند في كشمير وإسرائيل في فلسطين – يستخدمان مفهوم “التهديد الداخلي” لتبرير القمع. كل طرف يصف السكان الأصليين كمصدر خطر على الأمن القومي، وهو خطاب سياسي أراه شديد الخطورة.
عندما تُستخدم هذه اللغة لتبرير الانتهاكات اليومية، تتحول حياة البشر إلى معادلة أرقام وإحصاءات، بدل أن تكون حقوقًا وحرياتًا يجب احترامها.
في حديثي مع بعض الأكاديميين والناشطين، وجدت أن هناك شعورًا عالميًا بالتجاهل أو التمييز في التعامل مع القضيتين.
العالم الغربي، على سبيل المثال، يتعامل بحذر شديد مع الهند، ربما بسبب المصالح الاقتصادية والاستراتيجية، بينما في فلسطين هناك مواقف متفرقة لا تتجاوز البيانات الرسمية والشجب.
هذا ما يجعلني أستنتج أن المجتمع الدولي يطبق معايير مزدوجة في مواجهة الاحتلال والقمع، حسب مصالحه الجيوسياسية وليس حسب الحقوق الإنسانية.
كما أن هناك جوانب أيديولوجية يجب عدم تجاهلها. الخطاب القومي في الهند وإسرائيل يعتمد على تصوير السكان الأصليين كخطر وجودي، وهو ما يبرر التدابير القاسية بحقهم.
ككاتب، أرى أن هذا الخطاب هو واحد من أكبر التحديات، لأنه يرسخ في الوعي العام فكرة أن القمع أمر طبيعي وضروري، بينما هو في الحقيقة انتهاك صارخ للحقوق الإنسانية الأساسية.
أحيانًا أتساءل: لماذا يبدو أن العالم لا يربط بين الحالتين؟ لماذا يتم التعامل مع فلسطين وكأنها حالة منفصلة عن كشمير؟ بالنسبة لي، الجذر واحد: إنكار حق تقرير المصير للشعوب المحتلة، واستخدام القوة العسكرية والسياسية لتغيير الواقع الديموغرافي والسياسي. كل من كشمير وفلسطين مثالان على فشل النظام الدولي في حماية الشعوب المستضعفة.
على الجانب الآخر، هناك بعض الأصوات داخل الهند التي تحاول الدفاع عن موقف الحكومة. يقولون إن كشمير منطقة تواجه تمردًا داخليًا، وأن الإجراءات الأمنية ضرورية. وأنا أتفهم منطقهم القانوني، لكنني
أرى أن هذا التفسير يغفل الواقع البشري: السكان يعيشون تحت حصار يومي، يتعرضون للمراقبة المكثفة، ويُحرمون من حقوقهم السياسية والاقتصادية. هذه السياسات تزيد من العزلة وتجعل من حل النزاع أمرًا مستحيلًا، بدل أن تساهم في “الاستقرار” كما تدعي الحكومة.
ما يربكني أكثر هو التكرار المستمر للنماذج نفسها. في فلسطين، نرى المستوطنات، الهدم، الحصار، والتوسع العسكري. في كشمير، تتكرر الصورة، مع اختلاف الوجوه والخرائط فقط.
هناك جنود في الشوارع، نقاط تفتيش، كاميرات مراقبة، ومنازل مهدمة. وهذه ليست مجرد تفاصيل، بل حياة يومية تُستنزف على مرأى العالم.
أحد الشباب الكشميريين قال لي مرة: “نشاهد صور غزة ونشعر أنها مدينتنا. الوجوه مختلفة لكن الألم واحد”. بالنسبة لي، هذه الجملة تلخص كل شيء.
الإنسان الذي يعيش القهر سيعرف الألم في أي مكان، بغض النظر عن الاسم أو العلم. وهذا ما يجعل القضية ليست مجرد نزاع جغرافي أو سياسي، بل قضية إنسانية أخلاقية عالمية.
في السياق الدبلوماسي، هناك تحركات متفرقة، ولكنها غالبًا ضعيفة التأثير. بعض الدول الإسلامية تحاول ربط القضية الفلسطينية بالقضية الكشميرية، لكن التحرك الدولي ما زال متأرجحًا بين البيانات الرسمية، المؤتمرات، والقرارات الرمزية.
أنا أرى أن هذا الانقسام الدولي يتيح للحكومات الممارِسة للسيطرة استمرار سياساتها دون مساءلة حقيقية.
ما يجعل الأمر أكثر خطورة هو أن التعاون بين الهند وإسرائيل قد يتحول إلى مختبر جديد لتطبيقات السيطرة الحديثة. التكنولوجيا الأمنية، مراقبة الاتصالات، استخدام الذكاء الاصطناعي في تعقب السكان، كلها أدوات قد تُطبَّق لاحقًا في أماكن أخرى.
هذا ما يثير قلقًا كبيرًا في نفسي كمراقب للقضايا الدولية، لأنه يرسخ فكرة أن الاحتلال والقمع أصبحا صيغة مقبولة لإدارة النزاعات.
بالنسبة لي، الحل لا يمكن أن يأتي إلا من منظور حقوقي ودبلوماسي موحد. يجب أن يعترف العالم بحق تقرير المصير، وأن يوقف التغييرات الديموغرافية القسرية، وأن يفرض آليات محاسبة فعالة. من دون ذلك، سنظل نشاهد تكرار نفس المشاهد المؤلمة، على شاشات العالم، وكأن التاريخ يعيد نفسه بلا جدوى.
أعتقد أن هناك أيضًا دورًا مهمًا للإعلام المستقل والمجتمع المدني. التقارير الميدانية، الشهادات المباشرة، والتحليلات الدقيقة يمكن أن تساهم في كسر خطاب القوة والهيمنة. كما أن ربط قضيتَي فلسطين وكشمير في إطار إنساني عالمي يمكن أن يضع ضغطًا على الحكومات لتغيير سياساتها.
في النهاية، عندما أتأمل هذه التجربة، أرى أنها دعوة للوعي والمساءلة. لا يمكننا التغاضي عن التشابه بين النماذج القمعية، أو قبول أن الاحتلال والسيطرة العسكرية هما الطريقة الوحيدة لإدارة النزاعات. الشعوب، في كل مكان، تستحق الحرية والكرامة، ويجب على العالم أن يتحرك وفق هذا المبدأ.
أنا شخصيًا أعتقد أن المستقبل سيكون أفضل إذا استوعبنا درس التاريخ، وإذا قرر المجتمع الدولي أن يضع حقوق الإنسان فوق المصالح الاستراتيجية.
لا يمكننا أن نسمح بأن تصبح كشمير وفلسطين مجرد تجارب للسيطرة والتغيير الديموغرافي. كل ذلك يتطلب شجاعة سياسية، ووعيًا شعبيًا، وإرادة دولية حقيقية، لا مجرد بيانات وتصريحات.
في النهاية، لا أرى القضية فقط كصراع جيوسياسي، بل كمعركة أخلاقية وإنسانية. الشعب الذي يُحرم من تقرير مصيره يعيش مأساة يومية، ونحن كمراقبين وكتاب ومحللين يجب أن نرفع الصوت، نوثق، ونضغط نحو الحلول العادلة. هذا هو واجبنا الأخلاقي قبل أي اعتبار آخر.