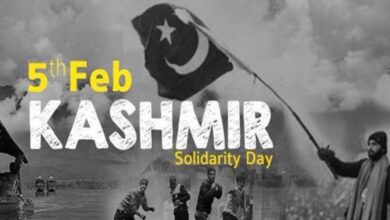الاستعمار الثقافي في كشمير: المشروع الحضاري الجديد للهند
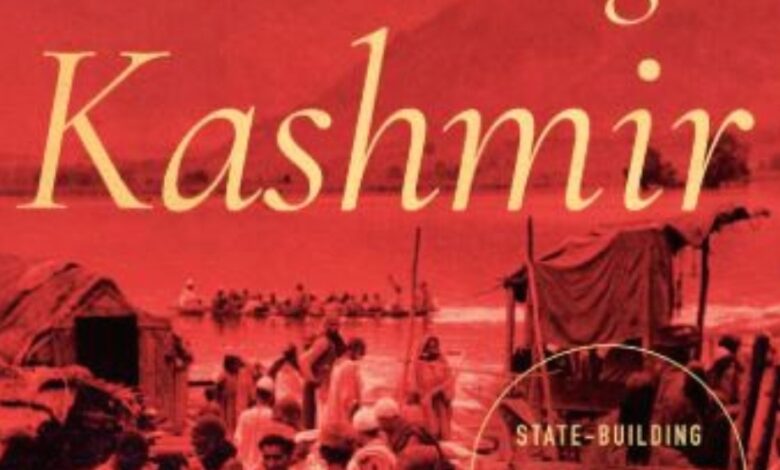
بقلم: مشتاق حسين
في جامو وكشمير المحتلة من قبل الهند، تُشنّ حملة ممنهجة تتجاوز السياسة بكثير. إنها هجوم أيديولوجي مدروس يهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الثقافية والحضارية للمنطقة. منذ إلغاء المادتين 370 و35أ من الدستور الهندي في 5 أغسطس 2019،
انتهجت نيودلهي استراتيجية مدروسة لمحو الطابع الإسلامي لكشمير وفرض نظام ثقافي إقصائي مستوحى من الهندوتفا.
برز مثالٌ حديثٌ وكاشفٌ على هذه السياسة في مهرجان كشمير الأدبي (KLF)، الذي افتتحه نائب الحاكم مانوج سينها في مركز شير-آي-كشمير الدولي للمؤتمرات في سريناغار. في كلمته، حثّ سينها الكُتّاب على “تصحيح الروايات التاريخية المشوهة بفعل التحيزات الاستعمارية من خلال البحث والنقد الدقيق”.
وبينما تبدو هذه التصريحات علميةً في ظاهرها، إلا أنها تحمل في طياتها مفارقةٌ عميقة – إذ حظرت الإدارة نفسها، بتوجيهٍ من سينها، ما يقرب من خمسة وعشرين كتابًا توثّق تاريخ كشمير الأصيل، وتراثها الصوفي، وسجلّ الهند في القمع الحكومي.
ألّف العديد من تلك الأعمال المحظورة كُتّاب غير مسلمين ناقشوا بنقدٍ التجاوزات الثقافية والعسكرية الهندية في المنطقة. تعكس الرقابة أجندةً أوسع نطاقًا: تعزيز نسخةٍ تاريخيةٍ معتمدةٍ من الدولة، تمحو هوية كشمير التعددية والإسلامية، وتستبدلها بروايةٍ حضاريةٍ هندوسيةٍ متجانسةٍ تتماشى مع الإطار الأيديولوجي لحزب بهاراتيا جاناتا (RSS).
ومع ذلك، لطالما تجذرت روح كشمير في تقاليدها الصوفية العريقة. وقد استنارت هذه الأرض بالتعاليم الروحية للسيد عبد الرحمن شاه بابول، والمير سيد علي حمداني، وشمس الدين العراقي، وهم شخصيات بارزة لم ينشروا الإسلام فحسب، بل نشروا أيضًا فلسفة التعايش والرحمة والمعرفة.
وقد ألهم إرثهم فنون الخط ونسج السجاد والورق المعجن والشعر في كشمير، وهي حرف أصبحت رموزًا للسلام والرقي في جميع أنحاء جنوب آسيا. واليوم، يواجه هذا التراث الروحي والثقافي خطرًا بسبب مشروع هندسة حضارية ترعاه الدولة.
لا تقتصر سياسة الهند الحالية في كشمير على السيطرة السياسية فحسب، بل هي استراتيجية شاملة للتحول الثقافي والديني والديموغرافي.
منذ إلغاء المادة 35أ، التي كانت تحمي سابقًا حقوق الإقامة المحلية والأراضي، أصدرت الحكومة آلافًا من شهادات الإقامة لغير المقيمين، مانحةً إياهم الحق في شراء الأراضي والاستقرار الدائم في الإقليم.
وقد كشفت رئيسة الوزراء السابقة، محبوبة مفتي، علنًا عن نقل آلاف الأفدنة من الأراضي إلى غير الكشميريين منذ عام 2019.
وهي خطوة وصفها الخبراء بأنها محاولة لتغيير التركيبة السكانية للمنطقة ذات الأغلبية المسلمة.
إلى جانب هذه الإجراءات الديموغرافية، شنّت نيودلهي هجومًا على التراث التعليمي واللغوي لكشمير. عُدِّلت المناهج الدراسية لتعزيز اللغتين الهندية والسنسكريتية على حساب الأردية.
بينما تُمجِّد الكتب المدرسية “الهوية الوطنية الهندية” الموحدة على حساب السرد الثقافي والديني المتميز لكشمير.
ما كان في السابق مجتمعًا متعدد الأعراق والأديان، صاغه الفكر الصوفي، يُعاد تأطيره الآن كامتداد هامشي للحضارة الهندوسية.
يُضيف استخدام الدولة للعنف وإفلاتها من العقاب بُعدًا آخر لهذا المشروع. فقد وثّقت منظمات حقوق الإنسان العديد من المواجهات الوهمية وعمليات القتل خارج نطاق القضاء للمدنيين منذ عام ٢٠١٩. حتى الدكتور سانديب ماوا، وهو زعيم محلي في حزب بهاراتيا جاناتا، أقرّ بأن القوات الهندية المتورطة في المواجهات الوهمية قد كوفئت بالترقيات والأوسمة.
تكشف هذه الاكتشافات حقيقةً مُرعبة، وهي أن القمع في كشمير ليس حالة شاذة، بل سياسة مُؤسسية.
كما اشتد التمييز الديني. حظرت السلطات احتفالات عيد الفطر، ومولد النبي (صلى الله عليه وسلم)، وعاشوراء، بينما تُحتفل بالأعياد الهندوسية برعاية حكومية كاملة. وأُغلقت المساجد التاريخية، بما فيها المسجد الجامع في سريناغار، مرارًا وتكرارًا لأداء صلاة الجمعة.
والنمط واضح لا لبس فيه: تسعى الدولة الهندية إلى فرض نمط من التوحيد الديني يُعطي امتيازات للأغلبية الهندوسية، بينما يُهمّش المسلمين داخل وطنهم.
تُعتبر هذه التطورات مجتمعةً شكلاً من أشكال الاستعمار الثقافي. إن استخدام الهند للقانون والتعليم واللغة والدين كأدوات للسيطرة يُحاكي الأساليب الاستعمارية الكلاسيكية.
إلا أن المستعمر والمستعمَر يتشاركان هذه المرة تاريخًا متنازعًا عليه داخل شبه القارة الهندية نفسها. تهدف هذه الحملة، التي تتخفى وراء ستار “التكامل” و”التنمية”، إلى تفكيك الهوية الأصلية لكشمير واستبدالها بقومية مُصطنعة تُعرّفها مبادئ الهندوتفا.
بالنسبة للمجتمع الدولي، لم تعد كشمير مجرد نزاع إقليمي أو سياسي، بل أصبحت اختبارًا لحقوق الإنسان العالمية والحريات الدينية والقانون الدولي. إذا استمرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان العالمية في الصمت، فسيكون هذا الصمت تواطؤًا فيما لا يمكن وصفه إلا بالإبادة الثقافية.
ومع ذلك، ورغم القمع المستمر، لا يزال الشعب الكشميري صامدًا في نضاله للحفاظ على تراثه ومعتقده وكرامته.
وبالنسبة للأصوات الواعية حول العالم صحفيون وأكاديميون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومواطنون عاديون يكمن التحدي في الاعتراف بصرخة كشمير، لا كمظلومية إقليمية، بل كنداء عالمي للعدالة.
كشمير ليست مجرد قطعة أرض، بل هي رمزٌ للتناغم الروحي والتنوع الثقافي والمرونة الإنسانية، وهي الآن رمزٌ محاصر. إذا استمر العالم في تجاهلها،
فقد تتذكر الأجيال القادمة كشمير ليس كـ”جنة على الأرض” كما كانت في السابق، بل كقصةٍ تحذيرية، حضارةٌ اندثرت في صمتٍ بفعل آليات الاستعمار الحديث