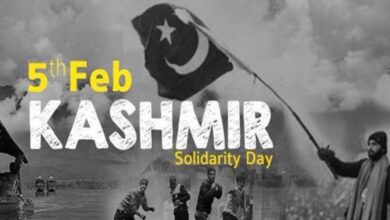اتفاقية مناهضة التعذيب.. والدروس المستفادة من كشمير وفلسطين وسوريا

ناصر قادري
من الزنازين المظلمة والرطبة في سجن صيدنايا سيئ السمعة على مشارف دمشق، تخرج قصص مروعة عن ناجين؛ أهوال تتحدى الفهم البشري: التعذيب المنهجي، والإعدامات خارج نطاق القضاء، والتجويع كسلاح في الحرب.
إن سجن صيدنايا، الذي كان في السابق رمزاً للحكم الاستبدادي لبشار الأسد، أصبح الآن بمثابة إدانة دائمة لتردد القانون الدولي في مواجهة “الجرائم ضد الإنسانية” التي يتم تطبيعها.
ووصف صالح، رئيس منظمة الإنقاذ التطوعية ” الخوذ البيضاء “، السجن بأنه “جحيم على الأرض”، وقال إنه ساعد ما بين 20 ألفاً إلى 25 ألف سجين في عمليات الإنقاذ.
وعلى مدى أكثر من خمسين عاما، ارتكبت عائلة الأسد هذه الجرائم الدولية مع إفلاتها من العقاب، ودون أن تخضع لرقابة النظام القانوني الدولي الذي يهدف إلى منع مثل هذه الفظائع.
ولكن سوريا التي مزقتها الحرب ليست حالة شاذة.
في مختلف أنحاء الجنوب العالمي – الذي يمتد عبر جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وخارجها – تعكس السجون وغرف التعذيب والوحشية التي ترعاها الدولة الإرث البنيوي العميق للاستعمار.
إن هذه الظاهرة متجذرة في التاريخ الاستعماري لدول الجنوب العالمي، حيث لم تكن ممارسات العنف المؤسسي موروثة من القوى الاستعمارية الأوروبية فحسب، بل كانت في كثير من الأحيان جزءًا لا يتجزأ من الحكم ما بعد الاستعماري، وقوات الشرطة، والأنظمة القضائية – والتي صممت في الأصل لقمع الرعايا المستعمرين.
في حين يدعي المجتمع الدولي عدم التسامح مطلقًا مع التعذيب، فإن تناقضاته مع هذه المناطق في التمييز بين شدة أو شدة الألم أو المعاناة التي تبرر تسمية “التعذيب” كانت غامضة في الفقه القانوني في الجنوب العالمي.
لقد تم تقليص ما يسمى بعالمية القانون الدولي إلى مجرد نطاق جغرافي. فالحظر والمساءلة يخدمان أجندات إمبريالية واستعمارية جديدة، ويعززان الهيمنة الغربية بشكل خفي.
إرث العنف الاستعماري
إن القانون الدولي المعاصر يتجاهل مرارا وتكرارا الطبيعة الموروثة للعنف المؤسسي في الدول التي نشأت بعد الاستعمار.
وفي مختلف بلدان الجنوب حول العالم، تم الاحتفاظ إلى حد كبير بجهاز الدولة، الذي أنشئ في البداية لفرض النظام الاستعماري، مع الحد الأدنى من الإصلاح بعد إنهاء الاستعمار.
وفي أفريقيا، لا تزال آفة وحشية الشرطة والتعذيب قائمة، حيث أثبتت نيجيريا وكينيا أنهما من الحالات الكلاسيكية لهذه القضايا. ففي نيجيريا، كانت فرقة مكافحة السرقة الخاصة (سارس) في قلب الإدانة العالمية بسبب انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب.
وعلى الرغم من تشريعات مكافحة التعذيب التي صدرت في عام 2017، يواصل ضباط إدارة مكافحة التعذيب العمل دون عقاب، ويرتكبون انتهاكات واسعة النطاق مثل الابتزاز والتعذيب وسوء المعاملة، دون محاسبة أي ضابط على هذه الجرائم المروعة.
وعلى نحو مماثل، عملت عملية مكافحة التمرد البريطانية في كينيا أثناء انتفاضة الماو ماو على تطبيع التعذيب باعتباره آلية سيطرة معتمدة من قِبَل الدولة. وقد انعكس هذا فيما بعد في قضية موتوا ضد وزارة الخارجية والكومنولث (2011) ، حيث كان نشر الإمبراطورية البريطانية لأنظمة الطوارئ المسلحة بمثابة مبرر قانوني لاستخدام العنف.
ولا يقتصر هذا الإرث الاستعماري على أفريقيا. فقد أنشأت بريطانيا قوات الشرطة في جنوب آسيا، وخاصة في الهند وباكستان وبنجلاديش، بموجب قانون الشرطة الصادر في عام 1861.
ولا يزال هذا الإرث الاستعماري يؤثر على ممارسات الشرطة المعاصرة، مع الحد الأدنى من الإصلاحات البنيوية على مر السنين. وقد أدى الإبقاء على نماذج الشرطة التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية إلى ظهور قضايا مستمرة مثل التعذيب أثناء الاحتجاز، والاحتجاز التعسفي، والقتل خارج نطاق القضاء، والتي استُخدمت في البداية لقمع الحركات المناهضة للاستعمار.
وفي بلدان الشرق الأوسط، وخاصة سوريا، تحمل معاملة المعتقلين تشابهاً ملحوظاً مع أساليب مكافحة التمرد البريطانية المستخدمة خلال فترة الانتداب، وهو ما يسلط الضوء على التأثير الدائم للعنف الاستعماري.
آلية التنفيذ المعيبة
في العاشر من ديسمبر 2024، وبينما كانت عائلات المختفين في سوريا تبحث بشكل يائس عن أحبائها في مراكز التعذيب التابعة لنظام الأسد، احتفلت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف ومجموعات حقوق الإنسان الأخرى في اليوم العالمي لحقوق الإنسان بالذكرى الأربعين لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وتنص هذه المعاهدة، التي تنطبق في وقت السلم والصراع المسلح، على اتخاذ تدابير قانونية لمنع التعذيب ومعاقبة مرتكبيه في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية.
وعلاوة على ذلك، أنشأ البروتوكول الاختياري لعام 2002 آليات مراقبة أقوى لفرض المساءلة العالمية. ولكن بعد مرور أربعة عقود من الزمان، تكشف القيود المفروضة على اتفاقية مناهضة التعذيب عن تساؤلات خطيرة حول مدى فعاليتها في ضمان المساءلة عن “الجرائم ضد الإنسانية”.
وفي الأراضي المحتلة مثل فلسطين، تظهر بانتظام تقارير عن تعرض المعتقلين ـ كثير منهم أطفال ـ للتعذيب على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
ومع ذلك، تظل هذه الاتفاقيات القانونية الدولية عاطلة عن العمل في محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
وعلى نحو مماثل، في كشمير الخاضعة لإدارة دلهي، تم الإبلاغ عن أكثر من 432 حالة تعذيب أثناء الاحتجاز على يد القوات والشرطة الهندية في العقد الماضي. وتحدث تقرير للأمم المتحدة عن انتهاكات جسدية شديدة، مما أدى إلى إصابة الضحايا بإعاقات مدى الحياة، في حين كشف المبلغون عن المخالفات عن صدمات نفسية وأمراض واسعة النطاق بين الناجين.
المؤسسة الإنسانية: حياد أم تواطؤ؟
وحتى المؤسسات التي تتمتع بجذور عميقة في القانون الإنساني الدولي، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تواجه التدقيق بسبب حدودها.
أنشئت اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال معركة سولفرينو عام 1863، وهي مكلفة بموجب اتفاقيات جنيف بحماية ضحايا النزاعات المسلحة.
ومع ذلك، فإن حيادها -الذي غالبا ما يتم تأطيره باعتباره حجر الزاوية لمبادئها الإنسانية- كان في أغلب الأحيان يُترجم إلى الصمت والتواطؤ.
وللحفاظ على الحياد، اعتادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تقدم تقاريرها إلى الحكومات فقط وفي سرية تامة. ويسمح هذا النهج للمنظمة بالحفاظ على الثقة مع القادة العسكريين الوطنيين، ولكنه يحد من قدرتها على محاسبة الجناة علناً.
وفي سوريا، ورغم أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتمتع بالقدرة على الوصول إلى مرافق الاحتجاز، فإن دبلوماسيتها الحذرة تعطي الأولوية للتعامل خلف الكواليس مع نظام الأسد على الإدانة العلنية للتعذيب المنهجي.
وعلى نحو مماثل، تواجه اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين قيوداً على قدرتها على الوصول إلى مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وهو ما يعوق قدرتها على الاستجابة لحالات موثقة جيداً من المعاملة اللاإنسانية والتعذيب، بما في ذلك حالات الأطفال.
وفي الجزء الخاضع لإدارة الهند من كشمير، وعلى الرغم من التقارير المؤكدة عن حالات وفاة أثناء الاحتجاز، وتعذيب واسع النطاق، وأمراض مزمنة بين المعتقلين ــ وهو ما كشفت عنه وثائق مثل ويكيليكس ــ أوقفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملياتها وأغلقت مكاتبها في المنطقة، وانسحبت فعليا من واحدة من أكثر مناطق العالم كثافة سكانية عسكرية.
حدود القانون الدولي
إن القانون الدولي يفشل بشكل كارثي عندما يعمل على تعزيز هياكل السلطة القائمة بدلاً من تفكيكها.
ومن خلال السماح للدول القوية بممارسة نفوذها على تفسير وتطبيق المعاهدات، يعمل النظام على ترسيخ إطار قانوني انتقائي ومتواطئ.
قال ريتشارد فالك، المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة والباحث القانوني البارز، إن القانون الدولي، على الرغم من أنه يرتكز على مبادئ عالمية، فإنه يعمل في كثير من الأحيان كأداة لتعزيز المصالح الجيوسياسية على حساب الكرامة الإنسانية.
إن المشكلة لا تكمن في غياب الأطر القانونية، بل في تفسيرها الاستعماري الجديد وتطبيقاتها على الجنوب العالمي، والعنف الاستعماري الجديد المحير.
إن حظر التعذيب معترف به على نطاق واسع باعتباره قاعدة ملزمة من قواعد القانون الدولي. ويؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه “لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”. وحتى في حالات الطوارئ، فإن الحق في التحرر من التعذيب غير قابل للانتقاص.
تنص اتفاقية مناهضة التعذيب صراحة على أنه “لا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية مهما كانت – سواء كانت حالة حرب، أو عدم استقرار داخلي، أو حالة طوارئ عامة – لتبرير التعذيب”.
تلتزم الدول بمنع الأفعال التي لا ترقى إلى مستوى التعذيب ولكنها تشكل معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة.
ومع ذلك، فإن تطبيقه على المجتمعات المهمشة في الجنوب العالمي يكشف عن تناقض بين المبادئ العالمية وحقائق التنفيذ.
نظام عدالة ذو مستويين
في حين أن هذه “الجرائم الفظيعة” في الجنوب العالمي غالباً ما تُقابل بالصمت أو التنفيذ الانتقائي، فإن الفظائع في الشمال العالمي غالباً ما تثير الغضب الفوري والمساءلة القانونية بسبب استجاباتها وتأثيرها الأكثر أهمية.
يكشف هذا التفاوت عن عدم المساواة الهيكلية ذات المستويين في نظام العدالة : أحدهما يعطي الأولوية للسرديات القانونية للدول القوية وحلفائها بينما يُحيل ضحايا الجنوب العالمي إلى الغموض.
إن هذا ليس فشلاً للمبادئ بل فشلاً للسياسة. ذلك أن المؤسسات القانونية الدولية ــ التي تلتزم بالمعاهدات ولكن تحكمها الدول ــ كثيراً ما تكون متواطئة في الأنظمة التي صممت لمعارضتها.
ويرى المحامي المتخصص في قضايا الحرب ديفيد كينيدي أن القانون الدولي معيب بطبيعته في شكله الحالي، لأنه غالبا ما يخدم مصالح الدول القوية بدلا من دعم مبادئ حقوق الإنسان العالمية.
إن الجنوب العالمي لا يحتاج فقط إلى إدانات دورية أو إشارات رمزية من أعضاء مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة.
وهذا يتطلب نظامًا قانونيًا دوليًا يعطي الأولوية للعدالة على الجغرافيا السياسية ويدافع عن الكرامة الإنسانية عالميًا وليس بشكل انتقائي.
إن الدروس المستفادة من سوريا وفلسطين وكشمير صارخة: فبدون المساءلة، يخاطر القانون الدولي المعاصر بأن يصبح إرثا من الفشل، يطارد واضعي الدستور الذين طمحوا ذات يوم إلى أن يكونوا مهندسيه الأخلاقيين.
المصدر: TRTWorld والوكالات